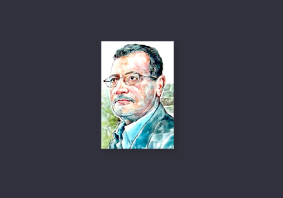
الشيخ صاحب
غادرت العراق مبعداً ولم أعرف بالضبط من هو الشيخ صاحب!
ربما يساعدني الآن أحد العراقيين بكشف تلك الشخصية التي لا تنسى، فقد كنت وقتها أعمل في دار ثقافة الأطفال، لكنني بلا سكن،
فبعد عملي بأسابيع كان صديقي المرحوم تركي عبيد قد منحني سريره في قسم داخلي قرب جسر الصرافية أبيت فيه، أما هو فقد كان سهلاً عليه تدبير أموره.
كان عبيد صاحب محاولات أدبية، فكثيراً ما كنا نلتقي ونسهر، ويطلعني على محاولاته الأدبية، والطريف أن مشروعه الأدبي دُفِن في مهده لسبب مؤلم، فقد نشر قصيدة في مجلة (الطليعة الأدبية) بتدخل مني عام 1977، وكان من عادة المجلة الحميدة أن تكلف أدباء مهمين بالتعقيب على المنشور في عددها السابق، وكان من سوء حظ صديقي تركي أن لسعه عبد الوهاب البياتي بكلمات قاسية جعلته يطوي صفحة النشر نهائياً!
تركي صديق وفي وقارئ ممتاز، وذات يوم جاءني مدهوشاً، وطلب مني مرافقته على الفور إلى أمام مقهى على الشارع قرب جسر الصرافية، قائلاً لي:
-أرجوك تعال معي! أكاد لا أصدق، لقد عثرت اليوم على كنز عجيب، شخص يبدو كشحاذ أمام المقهى ينام على الرصيف ويعيش فوقه، لكنه مثقف كبير، لقد جلست معه أكثر من ساعتين أسأله وأستمع إلى أجوبته ونصائحه، وقرأت له مما كتبت، فوجه لي ملاحظات في منتهى الذكاء والذوق والفطنة، أريد أن تتعرف بهذا الرجل العجيب، إنه بالنسبة إلي كأنه واحد من متصوفة بغداد ودراويشها الكبار الذين قرأنا عنهم كثيراً في بطون الكتب!
أسرعت مع تركي متلهفاًعلى هذه اللقية، وما إن اقتربنا من رصيف ذلك المقهى حتى رأيت رجلاً جالساً يترنح، وهو ينشد بعض الأبوذيات، فاقتربنا نستمع، وننتظر أن ينتهي الشيخ صاحب من غنائه، كان يتحلَّق حوله معنا بعض الشباب، ينصتون بتأثر، بينما تقف سيارة أحياناً فينزل راكبها بهدوء ويدسُّ قنينة في معطف الشيخ صاحب ويمضي، بينما لاحظت أن شيخنا بين حين وآخر يخرج من جيب معطفه (بُطلاً)، فيرتشف منه ثم يتألَّق غناءً، وحين ينهي وصلة من وصلاته الغنائية يتقدم منه المحيطون، فهذا يسأله سؤالاً ثقافياً، وآخر يطلب رأيه في قصيدة أو قصة دسَّها في جيبه قبل يوم أو أيام، والطريف أن الشيخ صاحب كان أحياناً تحت وطأة السلطنة والشرب يتوقف عن الكلام الجاد والإجابات وينطلق في واحدة من أبوذياته، لكن وسط احترام المحيطين، بل ما يشبه خشوعهم.
تكررت وقفتي تلك، حتى بعد انتقالي إلى السكن في مبني اتحاد الشباب في ساحة عنتر، وقد حاولت مراراً أن أعرف حقيقة ذلك الدرويش بلا طائل، فقد كان صاحب ثقافة موسوعية في اللغة والأدب العربيين قديماً وحديثاً، وفي الأدب العالمي واللغة الإنكليزية، وكنت أسأله أحياناً بشكل مباشر:
-شيخ صاحب! حضرتك أستاذ جامعي سابق؟
فكان ينظر إلي بعينين دامعتين، ولا يتكلم، بل ينطلق بأبوذية جديدة.
في الشتاء القارس لا يغير مكانه ولا جلسته تلك، وذات مساء شديد البرودة، وكان الجو زمهريراً قارساً رأيت الشيخ جالساً بدشداشته التي كانت بيضاء ذات يوم، ومعطفه الرقيق، وهو ينشد ويجيب عن أسئلة السائلين، لكنني قلت له:
-شيخ صاحب ألا تشعر بالبرد في هذا الجو؟
فنظر إلي نظرته المعروفة تلك، المعجونة بدموعه، وأجابني كدرويش أصيل وبالفصحى:
-يا بني! البرودة الوحيدة هي التي أشعرها في روحي فقط، جسدي لا يحس ببرودة ولا حرارة!
مضت أشهر لم أعد أرى (الشيخ صاحب)، فقد كنت أمر بمطعم صغير دوماً لشاب فلسطيني يحضِّر ألذ (جظ مظ) تناولته في حياتي قرب جسر الصرافية، وظننت أن الشيخ قد توفاه الله ربما، ومضت أسابيع وأسابيع، حتى حصلت تلك الحادثة المشؤومة مع الأصدقاء فاضل عواد وعبد الإله الصائغ وف. ح السوري.
بعد أن خرج صديقي السوري ف. ح قال لي:
-لن تتوقع ماذا رأيت داخل مديرية الأمن العام معتقلاً.
قلت بلهفة:
-من؟
أجابني:
-شخص وقور وحزين ومهشَّم الملامح…الشيخ صاحب! ماذا يريدون من رجل بيته الرصيف؟!
