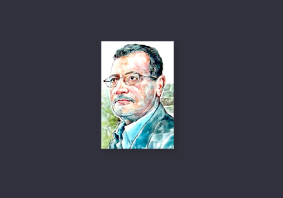
عبد الحسين محمود
بيان الصفدي /
وعبد الحسين محمود.. الذي يشبه غيمه خريفية راحلة، أو دمعة على وشك السقوط، أو أبوذية حزينة تحملها ريحُ عراق لا يرحم من له قلب فراشة!
في بداية عملي في مجلتي والمزمار عام 1977حصل أن ارتبطت بعبد الحسين برابط العمل المباشر والصداقة الصدوقة، فهو الذي رسم أولى قصصي وقصائدي فيهما، وصفحتي الثابتة في مجلتي باسم (السنَّارة) ورسم لي خمسة كتب أطفال صدرت عن دار الآداب في بيروت.
كانت خطوطه لافتة، فيها رشاقة وحركة راقصة، واختصار جميل، والأهم أنه امتلك خصوصية، فالمشاهد يعرف فوراً أنه يرى رسماً لعبد الحسين، فلم يكن يشبه أحداً، مع أنه في مطلع شبابه.
عبد الحسين شاب يميل إلى سمرة غامقة قليلاً، نحيف جداً، بعينين ذكيتين طيبتين، وكان ذا مزاج خاص، له عالمه الخاص المليء بأسرار خفية جميلة، فهو قليل الكلام، شديد الهدوء، وعاشق كئيب، وكان عشقه يظهر في شكل الطفلة التي يرسمها، كما قيل لي من أكثر من صديق له في معهد الفنون، وكان حبه مثله، هادئاً حزيناً شفافاً، فهو يحب زميلة له، لكنه لا يعبر عن ذلك حتى بكلمة صريحة ومباشرة لها، بل كان يكتفي بالاقتراب منها، وخاصة في النادي، حيث يجلس إلى طاولة مقابلة لها، ويترك نار العشق تشتعل في أعماقه، ويخفي لهبها عن الآخرين.
وأظنه يحمل صورتها في قلبه على الدوام، لهذا يظل شارداً ومحلِّقاً كأنه يسبح في سماوات لا نراها، لكنه عندما ينكبُّ على الرسوم، تنطلق كوامنه، فيخط بريشته تلك الرسوم المدهشة، وعندها ينقلب الهدوء إلى حركة راقصة رشيقة، وينصبُّ شلَّال الألوان من بين أصابعه غنياً فوَّاراً، فتتمايل الخطوط، وتتعانق وتفترق، وتعبث وتنطلق مبتهجة، فهي تتساقط من قلب عبد الحسين الذي يجدها فرصة ليسيل على الورق حرَّاً وسعيداً.
الوقت عند عبد الحسين مضطرب، فلا تعرف له موعداً محدَّداً مع شيء، فإن حضر إلى العمل أنجز المطلوب منه بسرعة وجمال وكثافة، لكنه ما إن يغادر مبنى المجلة حتى ينسى موعد العمل القادم، فقد يغيب أياماً قد يقضيها نائماً أو شارداً أو متسكِّعاً، وحتى لو عاتبه أحد عندما يعود ينفث دخان سيكارته، ويرتشف شايه مبتسماً، وكأن خطأ عابراً قد حصل، لهذا اعتاد الجميع على طريقة عبد الحسين في الحضور والغياب، وكانت السيدة أمل الشرقي تتفهَّمه كثيراً، لكنها تقول ضاحكة: “من يجي عبد الحسين الزموه ولا تعوفوه حتى يكمل كل المطلوب منه.”
فجأة اختفى عبد الحسين تماماً، فقد حان وقت ذهابه للخدمة العسكرية، وزاد الطين بلة أن الحرب مع إيران قد اندلعت، وأنت تستطيع تصور الجميع جنوداً، إلا عبد الحسين، ذلك الفنان الذي يشبه نسمة ناعمة متسللة من نافذة في منزل ريفي بعيد.
وكدت أنساه بعد أن طال غيابه، وطال سؤالي عنه، وزاد الخوف عليه، فلو أنه قبض عليه متخلِّفاً عن الجندية لخسر حياته.
ذات يوم دخلت مقهى (البرلمان) وإذا بي أرى جندياً يجلس في زاوية يشرب شايه، ودخان سيكارته يعبق أمامه، فعندما عرفته بصعوبه قائلاً: “معقولة عبد الحسين جندي أخيراً” ابتسم ابتسامة حزينة، مع دمعة حزينة.
عندما زرت العراق أول مرة بعد غياب طال رجوت أصدقائي أن يبحثوا عنه لأراه، وكانوا جميعاً يجهلون أين هو الآن، وبعد بحث حثيث نجحت الجهود في القبض مرة ثانية على عبد الحسين، وكم كنت سعيداً برؤيته من جديد، لكنه هجر الرسم واختار العمل في مطبعة.
أمضيت ساعات أصر فيها عبد الحسين أن يستضيفني في مطعم بغدادي جميل في شارع السعدون مع الأصدقاء بلاسم محمد وعلي المندلاوي وعبد الرحيم ياسر وصديق آخر نسيت اسمه كان له الفضل في اكتشاف مخبأ عبد الحسين الجديد!!.
