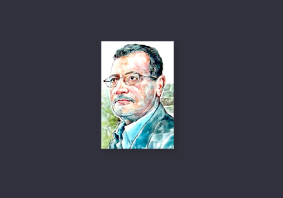
وصية السيّاب
بيان الصفدي /
يحسب ذات يوم للمنهاج المدرسي السوري أنه كان قد أقرَّ عام ١٩٦٨ تدريس السياب في الثالث الثانوي ضمن كتاب (التراجم والنقد)، فإضافة إلى أهمية تدريس الشعر الحديث لأول مرة آنذاك، فقد كان السياب اختياراً مميزاً، لأنه الشاعر الوحيد الذي جعل من شعر التفعيلة تياراً، لا مجرد خروج محدود على مألوف الشعر العربي.
وجاء متناغماً في التأثير كون حياة الشاعر مثالاً خصباً للفرح والعذاب الإنسانيين، ولكل ما يصادفه المبدع في مجتمعنا من تناقضات وظلم ومآسٍ وآلام، ليختم القدر مع السياب بمرض عضال نخر جسده نخراً، وإنْ ظلت روحه حتى اللحظة الأخيرة مشتعلة بالتوق إلى الحب والجمال والحياة، وظل العراق نبضه الأعمق في أقسى لحظات الوجع.
عندما ذهبت إلى العراق، كان السياب يختصر في خيالي العراق كله، فقد قرأته كاملاً، وتعلمت منه وتأثرت به، وظلت حياته مرتسمة في قلبي مثلاً لمأساة لا مثيل لها على كافة الصعد، الشخصية والعامة، الصحية والسياسية والعاطفية.
في العراق بدأت أرى صورة السياب تأخذ أبعاداً متعددة، فقد كان أمثولة فنية وعقبة أيضاً، نموذجاً كبيراً مع محاولات النيل من مكانته، لذا صعب على كثيرين أن يسلِّموا بأنه الرائد الأكبر للحداثة، وراحوا ينبشون في حياته وشعره عمَّا يخدش قيمة الشاعر. كما جرت محاولات بائسة لتهميشه أو حصره في زاوية سياسية ضيقة، فجعلوه شاعراً بعثياً، لا قومياً فقط، ولا يسارياً.
وظل التحدي الأكبر أمام الجميع أن السياب ظل الشاعر الكبير الذي مزج الشعر بالهمّ والناس، من دون أن يفقد الشاعرية، وجدَّد في الشكل التفعيلي من دون أن يهدم الذائقة العربية، وقبل هذا وبعده كان شاعر العراق بفرحه وحزنه، بآماله وخيباته، الشاعر الذي مجَّد ترابه ونخله وماءه وسماءه.
كل ذلك مع روعته الشعرية وهو يحول ألمه في سنواته الأخيرة إلى ملحمة خالدة من ملاحم المواجهة العميقة مع الموت، وتحويله إلى أفق رحب من التأمل والإبداع والتوهّج.
لقد رحل السياب في الرابع والعشرين من آخر شهر من سنة ١٩٦٤، لكنه رحل نحو قلوب العراقيين والعرب، وصار بحق الرمز الأكبر للشعر العربي الحديث، لكنه ترك قبل رحيله (وصية من محتضر) يقول فيها:
يا إخوتي المتناثرين من الجنوب إلى الشمال
بين المعابر والسهول وبين عالية الجبال
لا تكفروا نعم العراق
خير البلاد سكنتموها بين خضراء وماء
الشمس نور الله تغمرها بصيف أو شتاء
… فإن من طين العراق
جسدي ومن ماء العراق
