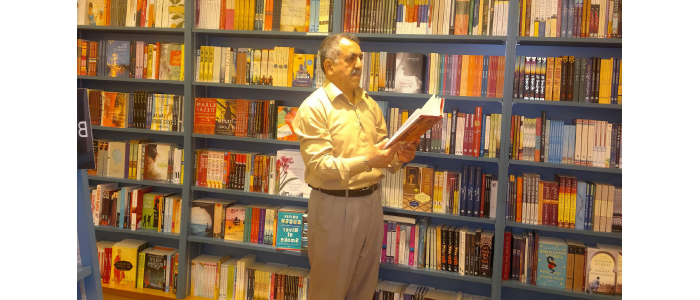
علي عبد الأمير صالح: الرواية وثقت ما مرّت به بلادنا من حروب وويلات
حوار/ علي السومري/
قاص وروائي ومترجم وطبيب، حصل على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة بغداد عام 1978، أصدر في السرد عدداً من المجاميع القصصية والروايات، من بينها: (الهولندي الطائر)، و(خميلة الأجنة)، و(أرابيسك)، و(يمامة الرسام). كما ترجم من اللغة الإنكليزية إلى العربية أكثر من خمسين كتاباً.
من كتبه : (حفلة القنبلة) لغراهام غرين، و(طبل من صفيح) لـغونتر غراس، و(راوي مراكش) لجويديب روي. نال جائزة وزارة الثقافة العراقية عام 2000 عن ترجمته رواية (طبل من صفيح)، وجائزتي الإبداع العراقي عام 2009، وعام 2017 عن روايته (خميلة الأجنة)، و(راوي مراكش) في حقل الترجمة.
إنه الكاتب علي عبد الأمير صالح، الذي كان لنا معه هذا الحوار الذي ابتدأناه بسؤال:
*أنت ابن السرد العراقي، ومعرفتكَ به عميقة جداً؛ كيف تقيّم ما يُكتب اليوم على المستويين المحلي والعربي؟
-لا أُخفيك سراً بأني مطلّع نوعاً ما على السرد المحلي أكثر من السرد العربي. وللعلم، لم يعد السرد يقتصر على القصة القصيرة والرواية والرواية القصيرة (النوفيلا)، بل بات يضمّ كُتب السيرة الذاتية والمذكرات. فهنالك، على سبيل المثال، كتاب فاطمة المحسن (الرحلة الناقصة)، وكتاب لطفية الدليمي (كراساتي الباريسية)، وكتاب علي جعفر العلاق (إلى أين أيتها القصيدة؟)، وكتاب عبد الله إبراهيم (أمواج: سيرة عراقية)، التي امتزج فيها بنحو جليّ العام بالخاص، وكذلك كتاب مي مظفر (سيرة الماء والنار). السرد المحلي والعربي يتقدّم باستمرار، ويستفيد بشكل واضح من تقنيات السرد الحديثة، وتعددية الأصوات، وتداخل الأزمنة والأمكنة، والتناص، والاستطراد، والاسترجاع والاستباق، والرسائل، والتقارير، والوثائق، والصحف، والكولاجات، والأحلام، وحضور عنصر الرواية داخل الرواية، ما يجعل بعض الروايات أشبه بمتاهة سردية فريدة تزدحم فيها الهواجس والأسئلة المقلِقة، المُعذّبة التي تكشف تمزق الإنسان المعاصر.
دورٌ تأريخي
* برأيك.. هل تمكنت الرواية من توثيق ما مر بالعراق من ظروف استثنائية، وهل يُمكن للمختصين في علم الاجتماع اعتماد الرواية العراقية كمصدر أساس في دراستهم المجتمع العراقي؟
– نعم، تمكنت الرواية العراقية من توثيق ما مرّت به بلادنا من حروب وويلات وعذابات، وكشفت مناخات الكبت والقمع والحرمان التي عاشها الشعب العراقي خلال النصف الثاني من القرن العشرين والعقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين. وبحسب تعبير (آذر نفيسي) إن “التهديد الأكبر الذي يواجه التعبير الحرّ اليوم هو العقلية الاستبدادية، التي ترسّخ الاستقطاب الآيديولوجي وتمنع التدفق الحرّ للآراء.” وبما أن “الأمم لا تتشكل إلا عبر سرديات ومرويات”، كما يقول إدوارد سعيد، لهذا وجد الروائيون العراقيون أنفسهم أمام الحاجة المُلحة لممارسة دورهم التاريخي في التعبير عن رؤيتهم الواقع والوجود والعالَم. ولدى قراءتنا لأعمال روائية مثل (بابا سارتر) و(مصابيح أورشليم) و(الحفيدة الأميركية) و(طشاري) و(فرانكشتاين في بغداد) و(المحبوبات) و(الحرب في حيّ الطرب) و(خان الشابندر)، على سبيل المثال، نطلع على شخصيات عراقية وعربية وأجنبية بهوياتها الإنسانية السردية، وتناقضاتها الأخلاقية والمعرفية، وأزماتها الآيديولوجية، وتغيّر قناعاتها الفلسفية. إذن، يُمكن للمختصين في علم الاجتماع أن يعتمدوا على الرواية العراقية كمصدر أساسي لدراسة المجتمع العراقي، وألا يعتمدوا على التاريخ الرسمي، لأن هذا التاريخ يكتبه المنتصرون، الذين قفزوا إلى السلطة بطريقةٍ أو بأخرى. أما الجنود الحقيقيون فهم المهمشون، المنسيون، على الدوام. ولا عجب أن يستشير الروائي الوثائق والسجلات، لكنه لا يهتم بالدقة التاريخية للأحداث. ليس الموضوع الموصوف هو المهم، بل الضوء الذي يقع عليه، مثل ضوء قنديل في حجرة بعيدة. وهذا ما فعلته (أولغا توكارتشوك) في روايتها المعنونة (أسفار يعقوب)، التي أثارت غضباً سياسياً وسط القوميين البولنديين.
الترجمة عبء موجع
* مَن يعرفك، يعلم جيداً أنكَ لم تكتفِ بكتابة القصة والرواية، وإنما انخرطت في الترجمة، ما الذي أضافته اللغة الثانية للروائي فيك؟
– الترجمة لم تضف لي شيئاً واحداً أو أشياء عدّة؛ بل صنعتني ثانيةً. تعيّن عليّ أن أُولد مجدداً. لقد ضخمَت شعوري بالحياة بوصفها عبئاً موجعاً، اضطهاداً مُميتاً، إذا جاز لي أن أستعير كلمات بابلو نيرودا. الترجمة فجّرت في طاقات المخيّلة، وكسرت حواجز التردد. لقد تخلصت من الخوف أو الخجل أو الحياء حين شرعتُ أتناول موضوعات حساسة، أو صادمة، لأننا بقدر ما ننتمي إلى عالمنا الحالي، فإننا ننتمي أيضاً إلى عالمنا الروائي الغرائبي، وشخصياتنا الروائية غالباً ما تكون (كولاجاً) لشخصيات عرفناها من قبل، وثمرةً لقراءاتنا وتأملاتنا. لقد غيّرتني كتب (آذر نفيسي) (أشياء كنتُ ساكتة عنها، جمهورية الخيال، ذلك العالَم الآخر: نابوكوف ولغز المنفى)، وكذلك كتاب (هايدين هيريرا) (فريدا: سيرة حياة فريدا كاهلو)، وكثيرٌ من الأعمال التي ترجمتُها التي تزيد عن خمسين عملاً. بفضل الترجمة تخلصت أخيراً من القيود التي طوّقتُ بها نفسي، وبت قادراً على التعبير عن ذاتي بشكل تام في كتاباتي السردية.
*هل تتفق مع مَن يقول إن الترجمة خيانة للنص الأصلي؟
– لا أتفق مع هذا الرأي. للعلم، هذه المقولة صارت (كليشة) جاهزة يرددها عامة الناس والمثقفون. الترجمة الجيدة هي إعادة خلق للنص الأصل بلغة أخرى. وللأسف يدفع الناشرون مبالغ زهيدة جداً للمترجمين، لأنهم لا ينظرون إلى عملهم بوصفه إبداعاً أدبياً. وذات مرة، قال ماركيز “أنا مُعجب جداً بالمترجمين، إنهم بديهيون أكثر منهم عقلانيون.”
وليس من الغرابة أن نجد الكثير من الكتّاب مارسوا الترجمة فضلاً عن الكتابة الإبداعية، وبذلك أضافوا رصيداً جديداً إلى إنجازاتهم في مجال السرد أو الشعر، ذلك أن ترجمة كتاب جديد، تمنح الكاتب سعادةً إضافية، سعادة العيش في عالم آخر أبدعه زميل لنا، هنا أو في مكانٍ آخر من العالَم، وهذا هو ما خبرتُه خلال ترجمتي لرواية (ساراماغو) الفريدة (العمى)، التي عدّها كثيرون واحدةً من أفضل ترجماتي.
* كيف يجري اختيارك للكتاب الذي تنوي ترجمته؟ وهل تترجم ما تتمنى كتابته؟
– في غالب الأحيان، أختار أعمالاً روائية أو كتباً ذات أهمية كبيرة في ثقافاتها ولغاتها الأصلية، ومؤلفوها أصحاب سمعة جيدة في بلدانهم أو ثقافاتهم أو لغاتهم، ناهيك عن اللغات والثقافات الأخرى. مثل رواية (طبل من صفيح) لغونتر غراس، ورواية (الجبل السحري) لتوماس مان، ورواية (لا تقولوا إننا لا نملك شيئاً) للكاتبة الأميركية من أصل صيني مادلين ثين. هذه الكتب قريبة إلى عالمي، وذائقتي، وتوجهي الفكري، لكن من الصعب القول إني تمنيتُ كتابتها. وعودةً إلى مسألة اختيار الكتاب المترجم، في بعض الأحيان، الناشرون هم الذين يختارون الكتب ويدفعون حقوق ترجمتها إلى العربية، ومن ثم يطلبون من أحد المترجمين أو إحدى المترجمات نقلها إلى لغة الضاد.
حافز للإبداع
* كيف تُقيّم ما يُمنح اليوم من جوائز للرواية العراقية، وهل ترى أنها عامل جذب لاستمرار الكتابة؟
– الجوائز المخصصة للرواية العراقية مفيدة وضرورية، إنها تخلق روح التنافس بين الروائيين من الجنسين، وتحفزهم على الكتابة بنحو أفضل، وتدفعهم إلى العمل بلا كلل من أجل المضي قُدماً نحو موضوعات جديدة، والاستفادة من تقنيات السرد الحديثة، والكتابة بلغة ثرّة، وعميقة، والابتعاد عن العبارات المستهلَكة، والتشبيهات الجاهزة. وهذا الأمر يتطلّب، بالطبع، أن يكرّس الروائي نفسه للكتابة، كما فعل نجيب محفوظ، الذي قَبِل على مدى سنوات طوال بأدنى مستوى من العيش له ولأسرته. وهنا آتي على ذكر هذا الكاتب المصري الشهير، كي نتخذه قدوةً في الحرص على الكتابة والإخلاص لها، وليس الجري واللهاث وراء الشهرة الفارغة، وتملّق كُتاب المقالات الصحفية بغية كتابة متابعة سريعة عن عملنا الأدبي هنا أو هناك، في هذه الجريدة أو تلك. كما أنّ المردود المالي للرواية الفائزة بالجائزة ينفع الروائي أو الروائية مادياً ويمنحهما فرصةً لتلبية حاجات يومية ذاتية، أو أسرية، وشراء الكتب، بالطبع. وهذه الجائزة لا تأتي إلا بعد أن يتسلّح الكاتب الروائي بالمعرفة، بالرؤى والأفكار والخبرة و(الصنعة)، إذا جاز لي التعبير.
*ما جديدك؟
– في العام الماضي صدرت لي ثلاث روايات مترجمة: (التذكرة الزرقاء) لصوفي ماكنتوش، و(البحيرة) لياسوناري كاواباتا، و(لا خبر من غورب) لإدواردو مندوثا. ولديّ أربعة كتب بانتظار النشر، ثلاثة أعمال مترجمة: رواية ومجموعة قصصية وكتاب مذكرات، فضلاً عن كتاب نقدي عن السرد العراقي المعاصر.
