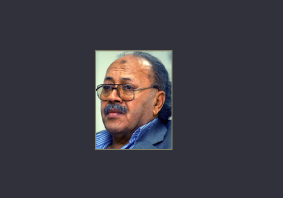
الكوسج الجنوبيّ
جمعة اللامي /
“إن عظَمة الفنّان تُقاسُ بالمحاولات التي قهرها”
(ألبير كامو)
في منتصف السبعينات، زارني في منزلي بمدينة الثورة مع صديق آخر، قال الصديق: هذا (فلان الفلاني)، ومنذ الآن سيكون اسمه آدم حاتم. تناولنا طعاماً أعدّ بسرعة وتحدثنا كثيراً في وقت قليل. كان يريد العيش في الصحراء الليبية. قال “سأكون هناك حيث لا يعرفني أحد”.
كنا نتحدث وقتها عن رامبو، ثم – فجأة – قطع حديثه وقال: حتى لو متُّ في الخارج، فلن تنساني الضفاف، وكانت الضفاف آنئذٍ شاهدة على لوعتنا: لقد خُدعنا بما فيه الكفاية، خَدعنا حتى الأقرب إلينا. وكنا – حسب قول الجواهري – كالزروع شكلت محولاً، فلما استمطرت مطرت جراداً.
فجراً، غادر آدم حاتم منزلي. بعد ذلك بخمس سنوات التقيته في بيروت، وبعدها في دمشق، ثم في قبرص وأثينا، كان قد أصبح أكثر نحافة، وأكثر قابلية للغواية، وكان يبدو لي كانه يخفي عني سرّاً شخصياً، تماماً كما يخفي هزاله تحت ذلك “البالطو” الأسود الثقيل الذي عُرف به.
كان آدم حاتم يبحث عن مشروع أدبي وثقافي جاد في أوضاع غير جدية. وهذه معضلة حقيقية. وعندما كنت أتحدث معه في هذا الشأن كان يبدي اعتراضاً هنا وتأييداً هناك ، ثم نتفق على شيء قابل. ولكن ما إن يحلّ المساء، كل مساء، حتى تضيق المدينة بنا: أية مدينة لم توجد بعد إلا في أذهاننا، قادرة على احتمال جنوننا وصخبنا وخرابنا السعيد الذي نحمله بين جوانحنا؟!
لا مدينة قادرة على ذلك، لا قارة تتحمل هذا الخبال السومري المدوّخ. لذلك كان الأصدقاء الأقربون -من العرب خصوصاً، يتقبلونناـ أول الأمر. هم يعرفون ما في ذاكرتنا من جيوب ودهاليز سرية. يعرفون أيضاً أننا في الغبش أكثر يقظة، وفي الظهيرة أكثر اعتسافاً مع الذات، وفي العصاري أكثر حذراً من كل الصباحات التي شهدتها المدن التي ترحب بنا علناً، لكنها تلعننا في السريرة!
لكن حتى هؤلاء الأصدقاء، في لحظات، كانوا أقل طهراً وبراءة منا، ربما لأن جيوبنا خالية إلا من أوراق مدعوكة، وأوراق مزورة وأقلام لم يجف حبرها بعد.
الآن.. ينطوي آدم حاتم على نفسه كطيّ السجل للورق، وينسحب “الكوسج” الجنوبي إلى الأصقاع القصية من شط العرب، يشقّ الماء. بسيف من كلمات.
أيها العرب.. لا مقام لكم!!
صراخُ قلب
بقيتّي ،
كفنٌ من الجوار المحمدي،
وكتابُ شعرٍ مؤجل ،
لي نصف الكفن.
ولكَ نصفه الآخر.. والشعر،
يا أجمل المنافي
وآخر الأرصفة
